في العلم والصحافة العلمية 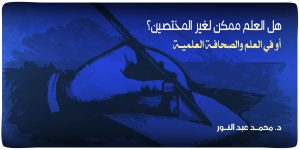
من مبادئ العلم المعروفة أن العلاقة بين المختص وغير المختص علاقة تصديق وتبعية، حيث لا حول للمريض إلا الامتثال لوصفة الطبيب وأوامر الصيدلي[1]، كما أن المختصون هم بمثابة ملجأ روحي يملأ حيرة وقلق الناس أوقات الأزمات والنكبات ويرأب صدع قلوبهم بالتفاسير المطمئنة أو بالاحتياطات اللازمة.
ثم يأتي كاختصاص وسيط الإعلام العلمي، ذلك الذي ينقل المعرفة المتخصصة إلى جمهور المتابعين ممن لا قدرة لهم على استيعاب التراكم التكويني المطلوب فضلا عن التجريدات والتصورات غير الممكنة إلا لأهل الاختصاص، ينقلها بشكل مبسط في شكل شروح تختصر الكثير من المسافات، ما يميزها هو الطرح التشويقي البعيد عن التجريد الممل بالنسبة للجمهور، إذ تجب الإشارة إلى أن الملل ذاك لا ينسحب على المختصين من ممارسيه فهم يجدون فيه ذروة الإثارة بما يجذبهم للبقاء في معتزلاتهم وخلواتهم العلمية الأيام والليالي، الأمر الذي يجد فيه غير المختص جهودا فارغة لا طائل من ورائها! خاصة وأن السؤال العلمي الحديث بعيد عن الغائية التي لا يجد من دونها الجمهور مغزى لوجوده، ذلك أنه سؤال دقيق غايته تفكيك أسرار العالم دون هوادة[2].
إذن الإشكال حاصل هنا بين الإثارة الحسية المباشرة لعروض الصحافة العلمية، والإثارة التجريدية والتصورية للمختص العلمي أيا كان اختصاصه، إذ لو كان العرض الحسي كافيا فلماذا يشقى المختصون طول أعمارهم، بينما الأمر يمكن أن يكون في المتناول خلال دقائق أو لحظات يجالس المرء فيها مجلة علمية موجهة لغير المختصين أو وثائقيا مصورا أو مسموعا. وبالمقابل نجد مثلا علماء الفيزياء يحتجون ويشنعون على عرض وثائقي لنظرية الكم اعتبروه تبسيطا مخلا بها، ذلك أن العرض الإعلامي يتغيا وضع النظرية بين حواس المتلقي إذ لا تكاد ترتفع به تصوريا حتى تعود إليه مخاطبة إياه وجاعلة منه بيت القصيد، وطبعا انسجاما مع المطلب الأول في الرسالة الاعلامية من تحقيق الأثر المباشر .
لذلك، يبدو حريا البحث في أسباب الهوة بين المختص والجمهور التي ما تفتأ تزداد بمرور الزمن الذي يتيح للأول التعمق أكثر والثاني الذي يعمل على إبقاء وعيه في سطوح الحس، ولسنا هنا في معرض الاعتراض على أي منهما. بقدر البحث عن حقيقة التباين والسؤال عن طبيعة الفارق بينهما؟ لا شك أن الأمر الشكلي الظاهر والجلي هو كما تقدم التدريب الذي يحصّله المختص في مجال اختصاصه، هذا التدريب الذي يمنحه مَلَكَة البحث للمختص لا يختلف فيه عن الصبي الذي تعود على خُلُق أو سلوك يدرب عليه، وهو ما لا يبقى مجرد سلوك مفرد بل ينقلب في درجة ما ليصير روحا تسكن المختص، روح يدرك فيها المختص تصورا وليس عيانا النتائج الممكنة لبحوثه ذات التساؤلات الدقيقة المبهمة الغاية ظاهرا، على غرار تجربة بافلوف في قياسه كمية سيلان لعاب الكلاب، ذلك أنها نتائج غير ممكنة العد من حيث انعكاسها على الحس مباشرة، فتصير المعادلة أنه كلما ابتعد المختص عن الحس كلما كانت نتائج بحثه أكثر فاعلية وانعكاسا عميقا على الحس. ثم إن الانعكاس يكون غير مباشر لذلك يغفل عنه الجمهور إلا بعد أن يعايش تلك النتائج بزمن طويل، لذلك التساؤل يكون هنا ملحا عن أهمية الإعلام العلمي مادام لا يفيد إلا في كونه يختزل العلم بشكل مخل؟ فهل وظيفة الإعلام العلمي إلا الإخلال بمضامين العلم وتشويهها؟
قبل تأكيد الفرض أو نفيه، يرد سؤال من الأهمية بمكان متعلق بمدى كفاءة الإعلامي ذاته في المادة التي ينقلها هل هو مختص أولا في ما ينقل ثم هل هو مستوعب لما ينقل إذ قد يتطلب تحيينا أكثر لمعارفه التخصصية أو تكوينا أعلى من تكوينه؟ فالغموض يحصل هنا تحديدا، فحتى لو سلمنا جدلا باستيعاب الإعلامي للمادة التي ينقلها فإنه سيجمع بالضرورة بين اختصاصين أحدهما يمثل مضمون المادة المنقولة من المختص إلى الجمهور والآخر هو الخطاب الإعلامي وتقنياته التي تتطلب جهدا لا يقل عن الأول في تحصيله، هنا تكمن المعضلة الكبرى للإعلام العلمي الجمع بين أمرين شبه متنافرين، حيث الإجادة في أحدهما تقتضي الإخلال بالآخر[3]؟ يمكننا تحليل الإشكال إلى مبادئه فنعيد صياغته كما يلي: إن تحول المختص إلى الإعلام تعني تخليه عن الخلوة والعزلة العلمية المطلوبة إلى مخالطة الناس بما لا يترك له الخيار بالجمع بين الأمرين، والقضية ليس اعتباطا حديا بقدر ما هي موضوعية تتعلق بحدود كل مجال لا ينبغي أن يتعدى إلى الآخر وإلا فقد هويته.
المؤكد هو احتمال الواقع لتلك الازدواجية التي لا يحتملها منطق واجب الوقائع ذاته، أعني أن يؤدي الأعلام العلمي نفس وظيفة العلم هو أمر لا يمكن تصوره في الأذهان السليمة، خذ ذلك في علوم الطبيعة وعلوم الإنسان معا بما فيها السياسة والإعلام وانتهاء إلى الفلسفة، الاشتغال العلمي يبقى مفارقا للعمل الإعلامي الذي ليس في النهاية إلا عمل سياسي بامتياز، وذلك معنى تسميته بالسلطة الرابعة من السلط السياسية المباشرة، وإن لكل من المجالين صفات تخصه بينها ماكس فيبر في كتابه العالِم والسياسي.
والسؤال كيف تلتقي السياسة بالعلم؟ إذا كان العلم قائما على "النزاهة الفكرية" من خلال إقامة البراهين وتحديد العلاقات الرياضية والمنطقية وملاحظة البنيات الجوهرية لحقائق الطبيعة[4]، فإن الاشتغال السياسي يقوم على "مبدأ القوة" من خلال احتكار العنف الشرعي لبسط السيطرة[5]، ومن ثم فواضح البون الجلي بين مبدأ النزاهة الهادف إلى الحقيقة ومبدأ القوة الهادف إلى السيطرة. لا شك، أن من حق السياسة محاولة ترويض العلم لصالح السيطرة، وذلك حتى يتحقق التسخير بمفهومه الأتم، تسخير الطبيعة لصالح الإنسان، إلا أن الخطأ المفترض يتمثل في مصادرته قبل الوفاء بشروطه ونتائجه المطلوبة، بمحاولة حصرمته قبل تزببه! ينتج عن ذلك أصناف من العلماء والعلوم غير المكتملة البناء تنتج عنها تشوهات على مختلف المستويات الواقع… إن مما ساهم في اجتزاء العلم كممارسة ووظيفة تحول غاية العلم الحديث من حب المعرفة والشغف بها إلى سعي مَرَضي إلى السيطرة، فلا يكاد العالِم ينتشي باكتشافه حتى تدفعه الرغبة المؤسسية في السيطرة إلى بحث موال وهكذا في دوامة لا متناهية أضحت من خلالها السيطرة ميتافيزيقا العلم الحديث[6]، ذلك الذي انعكس على التصورات الراهنة للعلم من قبل المشتغلين عليه – المختصين- قبل الساعين للإفادة منه وتسخيره.
يتحول المختص إلى مجرد إعلامي معتمد في الإفتاء في قضايا تخصصه، حيث لا يلبث أن تفرض عليه الضرورة الإعلامية الإدلاء بآراء وفتاوى غير خاضعة للتحكيم العلمي الضروري، وحسب بونيفاس لا تغدو النزاهة معيارا يحكم الأمور في وسائل الإعلام، فتعطى الأولوية غالبا لذاك الذي يفرض كلامه بطريقة قطعية[7]، بما يحدث فارقا بينه وبين أصحاب التخصص بحيث لا يكون المنفذ له من الإحراجات إلا بناء قلعة محرمة تدعمها المصالح ويحرسها جنود موكلون بذلك أيضا، والأدهى أن الرفاق في التخصص سيخضعون أيضا للضرورات الإعلامية، ويتحول الجدل العلمي إلى تناوش إعلامي صرف يكون العلم والحقيقة خلالها آخر ما يفكر فيه.
والمعضلة كما تقدّم لا تكمن في تسخير العلم لصالح القوة السياسية وسيطرتها بقدر ما تكمن في إخضاعه إلى شروط الإعلام، ولإدراك إمكان الفصل بين العلم والإعلام يكفي العمل على إبقاء المختص في مخبره أولا لإنضاج بحوثه على الوجه الأكمل والتعامل مع نتائج البحث لا مع المختص، يتصور ريجيس دوبريه أن هناك استحالة في الجمع بين شكل التعبير والتفكير؛ ولقد بات الخبراء وجها آخر يتواتر ظهوره في النقاشات إلى جانب الإعلاميين، والحد ملتبس أحيانا بين الصنفين[8]. والغاية من ذلك تعميق المعارف، تسليما بأن لا حدود للعلم يتوقف عندها خاصة بعد انبثاق فكرة التقدّم عند الإنسان الحديث، ذلك أن هناك دائما إمكانية تقدّم جديد بالنسبة لمن يعيش في التقدم، هذا التقدّم الذي يشارك فيه العلم كعنصر محرّك[9]، وهنا تحديدا نكون أمام مفارقة أخرى تتمثل في لا تناهي العلم وتقدّمه المستمر مقابل لا تناهي المادة الإعلامية أيضا، إذ يُبهِم الأمر على المختص والإعلامي معا فضلا عن المتلقي في طبيعة اشتغال كل منهما بالخطاب، فالخطاب العلمي والخطاب الإعلامي لاشك مختلفا الغاية كما تقدم، وأن التقاءهما لا يكون إلا بعد تمام العلم واستيفاء شروطه، ذلك ما يمكن أن يقحمنا ليس إلى اللحاق بركب الحضارة ولكن أيضا إلى تصويب مسار التقليد العلمي وميتافيزيقاه المحصورة في السَّيطرة.
نُشر أول مرة على موقع نماء، الرابط: http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=30607
——————————————————-
[1] – برتراند راسل، النظرة العلمية، ترجمة: عثمان نويه، دار المدى دمشق، الطبعة الأولى 2008 ص 12 ص 13
[2] – Le Désenchantement du mondeأو "فك السحر عن العالم" مفهوم صاغه ماكس فيبر للتعبير عن الغاية التي تحكمت بالحركة العلمية في أوروبا منذ بدايات الثورة العلمية مع كوبيرنيكوس وغاليليو وهو ما انعكس على فلسفة الإنسان الغربي ورؤيته للوجود عموما.
[3] – باسكال بونيفاس، المثقفون المزيفون، ترجمة روز مخلوف، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى 2013، ص 20
[4] – ماكس فيبر، العالم والسياسي، ترجمة سعيد سبعون، آسيا بومعيزة، دار القصبة الجزائر 2009، ص 37
[5] – المرجع نفسه، ص 59 ص 60
[6] – برتراند راسل، المرجع السابق، ص ص 239 242
[7] – باسكال بونيفاس المرجع السابق، ص 07
[8]– المرجع نفسه، ص 20 ص 21
[9] – ماكس فيبر، المرجع السابق، ص 24 ص 25





 اليوم : 193
اليوم : 193 الأمس : 183
الأمس : 183 هذا الشهر : 7858
هذا الشهر : 7858 هذا العام : 53781
هذا العام : 53781 مشاهدات اليوم : 700
مشاهدات اليوم : 700 مجموع المشاهدات : 583902
مجموع المشاهدات : 583902 المتواجدون الآن : 2
المتواجدون الآن : 2
أحدث التعليقات